قاطفة البرتقال المر
سامي مروان مبيّض (بيروت، 20 حزيران 2016)
في شمال شرق الولايات المتحدة، في “جامعة براون” العريقة في ولاية رود أيلاند، يتم العمل حالياً على جمع وتصنيف أوراق الأديبة والشاعرة السورية الراحلة سلمى الحفار الكزبري (1922-2006).
تتميز هذه الأوراق بدقتها وبلاغتها، وما بقي فيها من روح صاحبتها، التي أمضت عمراً بأكمله في خدمة التأليف والبحث، متنقلة بين سورية ولبنان وإسبانيا، حيث تعرفت على الشاعر الكبير نزار قباني، الذي كان يعمل في السفارة السورية في مدريد مطلع الستينيات. قبل وفاتها بخمس سنوات، جمعت مراسلاتها مع نزار المكتوبة بخط يده المنمنم والمعروف، صارت كلها اليوم ملكاً لجامعة براون. وكذلك مقالاتها وأبحاثها ومحاضراتها، وكل ما جمعته من مراسلات بين مي زيادة وجبران خليل جبران، التي وبموجبها نالت جائزة الملك فيصل العالمية للأدب العربي عام 1995.
في هذا الكنز الثمين قد نجد مخطوط كتابها الأول “يوميات هالة” الذي قدمته لروح الزعيم سعد الله الجابري، وكتاب “نساء متفوقات” الذي قدم له العلامة قسطنطين زريق، إضافة إلى رائعتها الأدبية “البرتقال المر” الذي تتحدث فيها سلمى الحفار عن مأساة الشعب الفلسطيني.
من يُبحر في أوراق سلمى الحفار يستطيع معرفة الكثير الكثير عن تفاصيل تلك الأديبة الدمشقية وعن عالمها الجميل الذي بات لا يشبه حاضرنا بشيء. فبعض تلك الأوراق مُعطر برائحة الهيل، وهو ما كانت تكتبه سلمى وهي تشرب قهوة الصباح الباكر، من غُرفة مطلة على أرض ديار منزل أسرتها الكبير في سوق الصوف، داخل حارات دمشق القديمة. وبعض الأوراق تفوح منها رائحة صابون الغار، التي كانت أمها “مسرّة السقطي” تغسل بها وسادتها وشراشف سريرها، قبل أن تنتقل سلمى للعيش في طرابلس الشام عند زواجها الأول من شقيق الرئيس عبد الحميد كرامي. أما عن الياسمين، الذي كان يُعرش على شباك غرفتها، والفل، الذي كانت تقطفه سلمى وتضعه في فنجانٍ صغيرٍ من الماء، لتؤنس به ليالي سهرها في دمشق، فكلاهما موجود في تلك الأوراق، مع رائحة البرتقال المر، والذي يعرف بدمشق بالنارنج.
لم تتصور سلمى في حياتها أن هذه الأوراق سوف ينتهي بها المطاف في مكان غريب وبعيد عن جذورها الدمشقية. فبعد وفاة والدها المرحوم لطفي الحفار قامت بإهداء مكتبته النفيسة إلى مكتبة الأسد وسط العاصمة السورية، إكراماً لما أوصى به، أن تكون في متداول يد الباحثين والطلاب السوريين من بعده. فالكثير من المكتبات السورية الخاصة وجدت مكاناً لنفسها داخل المكتبات العامة أو الجامعية، مثل مكتبة الدكتور عزيز شكري، عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق، التي باتت مكتبته اليوم موزعة بين جامعة القلمون ومعهد الفتح، ومكتبة سعد الله ونوس التي أهديت مؤخراً إلى الجامعة الأميركية في بيروت، ومكتبة صاحب “الأيام” نصوح بابيل، التي باتت أيضاً ضمن مقتنيات مكتبة الأسد.
ولكن أوراق سلمى الحفار نُقلت بعيداً إلى إحدى أقدم وأعرق الجامعات في العالم، بعد سنوات من رحيلها وعدم اكتراث أي من الجامعات أو المدارس العربية لإرثها الأدبي، ولا حتى الجامعة اليسوعية في بيروت، حيث درست في شبابها، أو مدرسة الفرنسيسكان في دمشق التي كانت سلمى من أولى طالباتها.
لم تتذكرها جامعة دمشق، وعندما ينسى أهل الدار مبدعيه يتولّى الغرباء جمع إرثهم وتخليد ذكراهم. مع الأسف، لا يوجد شارع في دمشق يحمل اسم “سلمى الحفار” أو اسم أبيها المناضل “لطفي الحفار،” الذي جلب مياه الفيجة إلى العاصمة السورية وكان رئيساً للوزراء وأحد الآباء المؤسسين للجمهورية السورية. لا شارع لهما ولا زقاق في “مدينة الفيجة،” ولا حتى قبر لسلمى في دمشق، كونها توفيت في بيروت خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006.
أكاد أن أجزم أن أوراق سلمى الحفار، ولو كانت بعيدة عن دمشق، ستكون بخير وبأيد علمية أمينة. ستكون محمية من نيران هذا المشرق، بكل ما فيه من توحش، والذي بات سكانه يحرقون الكتب بدلاً من قراءتها، ويقطعون رؤوس مؤلفيها، بدلاً من تقبيلها أو نحت تماثيل لها.
***

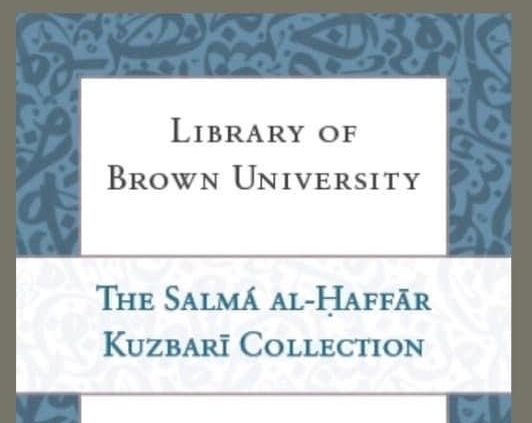


اترك رداً
تريد المشاركة في هذا النقاششارك إن أردت
Feel free to contribute!